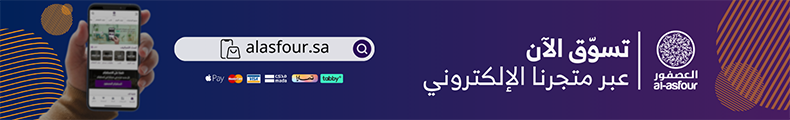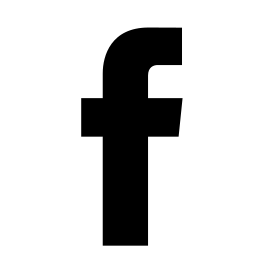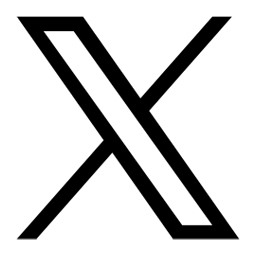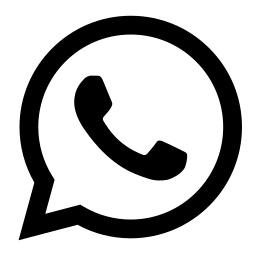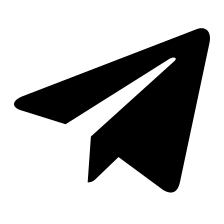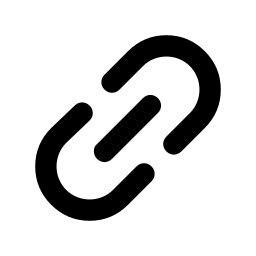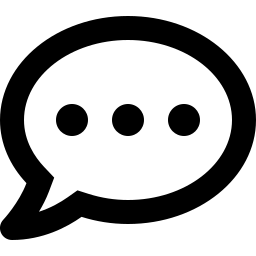لحظة كورونا الراهنة
ظاهرة الموضات في الثقافة المعاصرة أو الحديثة أشبه بفقاعة صابون بدأت منذ منتصف السيتنيات في بلد مثل فرنسا التي تعد صانعة الموضة بامتياز، ثم انتشرت نحو سائر أوروبا، وأصبحت مقولات «ما بعد الحداثة» أو «ما بعد البنيوية» تعبر تعبيرا مباشرا عن مثل هذه الموضات التي لها مناصروها ومعارضوها وأسماؤها المعروفة على المستوى الفكري والفلسفي والأدبي. والموضة ظاهرة ارتبطت بالأزياء والملابس وكل ما يتعلق بالجسد في سوق الاستهلاك الاجتماعي الذي جاء مع عصر الحداثة.
وأبرز سمات هذه الظاهرة هي السرعة في استهلاك الشيء وتجاوزه إلى ما هو أفضل منه وأحسن كقيمة تفاضلية في سياق التحديث في العلاقات الاجتماعية. ثم انتقلت هذه الظاهرة من الوسط الاجتماعي المرتبط بالجسد إلى الوسط الفكري الفلسفي المرتبط بسردية الأفكار الكبرى - من جراء تأثير هذا الوسط عليه - كمقولة التقدم، والحتمية ونهاية التاريخ.. إلخ.
ومثلما رأينا في تلك المقولات فإن كلمة «الما بعد» أو «الما قبل» تتضمن الفصل بين شيئين واضحين أو معروفين أين تقع حدود كل منهما، وهذه إحدى مخلفات الموضة التي سادت في تلك الفترة. لكنها خفت نوعا ما عندما تخلى الكثير من المفكرين عن مشاريعهم الكبرى، واختفت تلك المقولات اليقينية عن مجال نصوصهم وفلسفتهم، وانتهت معها الصرامة أو المعيارية في النظر إلى ظواهر الأشياء.
لكن ما أن يقع حدث مهم على مستوى العالم كما هو حدث الحادي عشر من سبتمبر أو غزو العراق أو ظهور داعش، حتى يجري النظر إليه بالطريقة ذاتها، وهو وضع الحدث على الحد الفاصل ما بين القبل والبعد.
فما قبل أزمة كورونا ليس كما هو ما بعدها. هذه المقولة الأساسية انبنت عليها الكثير من التحليلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وكأن الرؤية واضحة لما سوف تؤول إليه الأمور في نهاية المطاف.
فرغبة الإمساك بلحظة كورونا الراهنة نابعة من جانبين: الأول هو شعور الخوف الكامن في الوجدان الإنساني من سرعة المتغيرات التي لم ينحصر تأثيرها على شكل العلاقات الدولية وخريطة توزيع القوة بين الدول سياسيا واقتصاديا - ولو انحصر في هذه المنطقة لهان الأمر، مثلما رأينا في الأحداث المهمة السابقة - وإنما تجاوزها إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك، الواضحة كل الوضوح للعيان. أي شكل الحياة اليومية للناس، فالإيقاع السريع لحياة العولمة تحول إلى البطء، واستتبع ذلك فراغات شاسعة في حياة الناس اليومية، لم يتعود عليها الإنسان نفسه، فراغات في التواصل الاجتماعي، فراغات في الأحاسيس والشعور المستمدة من هذا التواصل، فالحزن والفرح والحب والرغبة هي بالنتيجة وثيقة الصلة بالجماعة أكثر من صلتها بالفرد، فراغات تصيب شكل التفكير السريع وتعطبه من الداخل.
بمعنى الإقدام مثلا على القراءة أو الكتابة وأنت في وضع كمن يمشي على حافة الهاوية، تفكر في سلامتك بالقدر الذي تريد أن تستوعب ما تقرأ، أو تكتب ما تفكر فيه بطريقة آمنة، ليس شبيها على الإطلاق وأنت في وضع كمن يمشي في غابة واسعة الأرجاء لا تفكر بالقراءة أو الكتابة إلا بالقدر الذي تصل فيه إلى نهاية الغابة.
لذلك الشعور بالخوف يتسلل من هذه الفراغات المؤسسة للحياة اليومية، ويعطيها الشكل المربك الذي نراه في تأويل الأحداث المرتبطة بأزمة «كوفيد 19».
أما الجانب الآخر، فيتعلق بالفضول المعرفي والثقافي الذي لا ينفك يمثل جزءا لا يتجزأ من بنية التفكير الإنساني، فهو الحافز على فهم اللحظة الراهنة الممتدة لجهة المستقبل، ومحاولة إدراك مفاصلها الداخلية. فهل بفضل هذا الجانب يمكن إدراك هذه اللحظة - لحظة كورونا - بكامل أبعادها كأننا قادرون على أن نثبتها في إطار ونقوم بالتقاط صورة لها؟.
إجابة مثل هذا السؤال بجميع تفاصيله يفرض علي - عزيزي القارئ - أن أفرد له مقالة مستقلة فيما يلي من المقالات الأسبوعية. لكن كإشارة موجزة لا يمكن على الإطلاق الإمساك بالحاضر مهما أحدثت هذه اللحظة من شروخات عديدة وواضحة، كثيرون حاولوا لكن الأغلب ذهبت محاولاتهم أدراج الرياح. بيد أن المخيلة الإبداعية بإمكانها أن تقول شيئا مهما في هذا الجانب. وهذا ما نتركه للمقال القادم.