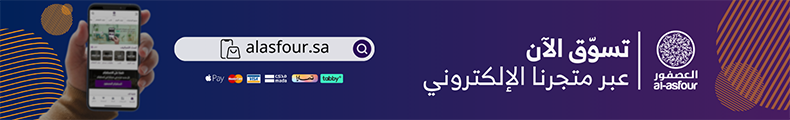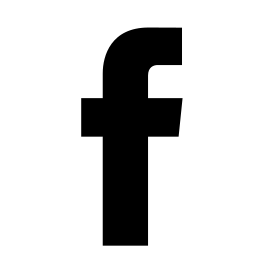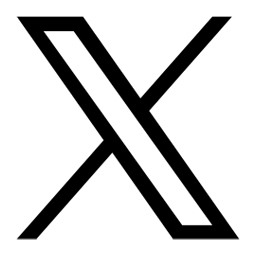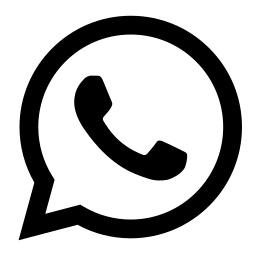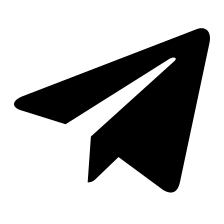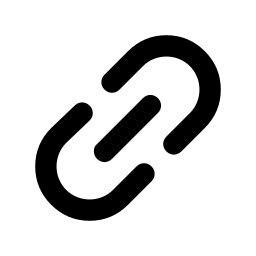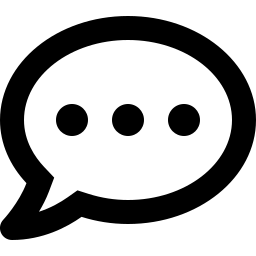ظاهرة التشابه داء عضال شعريا
هناك سبب وحيد يجعلني مقتنعا بأن ما يكتب من شعر في مشهدنا السعودي حاليا آخذ في الجمود ومفضيا إلى التنميط والصوت الواحد، بعدما كان في الثمانينيات والتسعينيات متعدد المشارب والأصوات، ولا يحتاج المرء إلى فطنة كبيرة؛ ليصل إلى مثل هذه القناعة، فالمشهد مفتوح على مصراعيه والكل يدلو بدلوه صغيرا كان أو كبيرا، فما عليك سوى أن تجيل بصرك في مواقع التواصل حتى تصل إلى تلك القناعة.
ولا يحتاج أيضا إلى مقاربات نصوصية لهذه التجربة أو تلك لتستخلص منها هذه القناعة، نموذج واحد منها يكفي كي تقيس عليها الباقي، فما يسمون أنفسهم بالشعراء بدأوا يتكاثرون كالفطر الذي ينبت فجأة، وسريعا ما يكون تحت الأضواء بقدرة قادر، والكل يشير إليه بالبنان باعتباره شاعرا فذا.
وما يزيد الطين بلة كما يقال، هو ضياع بوصلة الرسائل النقدية الأكاديمية - على الأقل حسب التي اطلعت عليها ووقعت في يدي - في متاهة الشكلانية النقدية والدرس الأكاديمي الصارم، الذي في الغالب يفصل الشكل عن المضمون والمضمون عن السياق الاجتماعي التاريخي.
أعود إلى السبب، الذي أفضى بي إلى تلك القناعة، وإن كنت مترددا في أن أجعله السبب الوحيد. لكن في ظني هو الوجه الظاهر والملاحظ كظاهرة نراها عيانا، بينما ما يختفي تحت السطح هو وجهها الباطن باعتباره أسبابا متعددة تلتقي من مشارب شتى: اجتماعية وثقافية وتاريخية وأدبية.
إن هذه الظاهرة المرتبطة بذلك السبب هي التشابه في إنتاج القصائد؛ وكي تتضح الصورة فيما أعنيه بهذا التشابه، أعطي المثال التالي:
بدافع البحث عن موضوع يصلح أن يكون لكتابة الشعر، يقوم بعض الشعراء من خلال حساباتهم على تويتر برفع صورة فوتوغرافية لوجه امرأة جميلة أو جزء من جسدها أو منظر طبيعي على خلفية موسيقية أو لوحة تشكيلية، إلى غيره من الحوافز، التي تساعد الشاعر على الكتابة، ثم يقوم بكتابة نص شعري يلامس أبعاد هذه الصورة أو تلك اللوحة، وهذا حق مشروع لا غبار عليه، شريطة أن يكون هذا النوع من التحفيز مرتبطا أساسا بالثقافة البصرية، التي لا تنفك يعايشها الشاعر في حياته اليومية. لكن واقع الحال في ثقافتنا المحلية، لم تتعرف على مثل تلك الحوافز إلا مؤخرا. الأمر الذي لا يسمح في القول إنها متناغمة مع حياة الشاعر.
لذلك نحن نتساءل هنا: ما الذي يجعل الشاعر يلجأ إلى استجلاب مثل هذه الحوافز؟! والجواب هو فقدانه للمواضيع، التي يستمدها من حياته الواقعية اليومية، وهذه بدورها لا تملك حياة صاخبة مليئة بالأحداث تؤهل الشاعر أن يكتشف موهبته ومخيلته على أرض متحركة الرمال.
إن حضور المرأة بوصفها تفاصيل جسدية أغلبها ما يكون متخيلا، في رؤية لا تخرج عن الأغراض الشعرية الموروثة، لأكبر دليل على أن الشاعر هنا يقع حافره على حافر شاعر آخر دون زحزحة، لا في الرؤية أو الشكل أو حتى المضامين، إلى درجة أن ترى شاعرا يقترح على آخر أن يصدر ديوانا يكتب فيه مفهومه للشعر. أووف.. مجرد الاقتراح علامة على إفلاس حقيقي. ناهيك بطبيعة الحال عن ثيمات أخرى بجانب صورة المرأة، لا مجال لذكرها الآن، جميعها تترك التشابة في كتابة القصيدة ظاهرة يتنمط من خلالها الشعراء.
أمامي مشهدان شعريان يمكن القياس عليهما، ألم يقل عمنا المتنبي «... وبضدها تتميز الأشياء»، وذلك في سياق ظاهرة التشابة وارتباطها بالحياة اليومية والثقافة على وجه العموم، هما المشهد الشعري السوري والمشهد الشعري العراقي بعد المآسي، التي عاشها الشعبان في السنوات الماضية الأخيرة وما زال. تجارب خارجة من رحم المعاناة، ورغم أنها متجايلة وقريبة من بعضها البعض إلا أن كل تجربة - كما هي أمامي - تمتلك خصوصيتها وصوتها المتفرد، وهذا ما لا أجده عندنا، وسوف أمثّل لبعضها. لكن في مقال آخر.