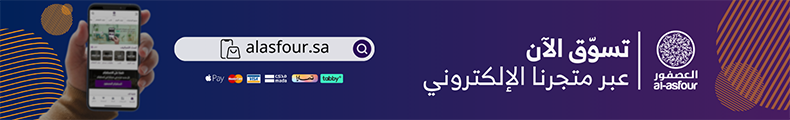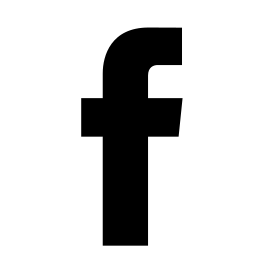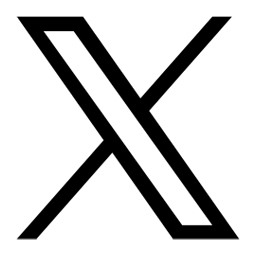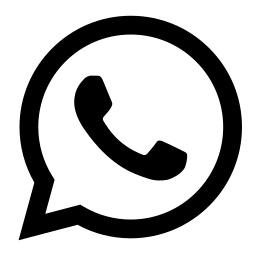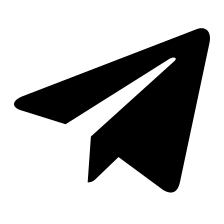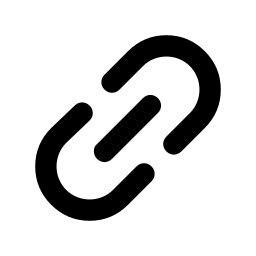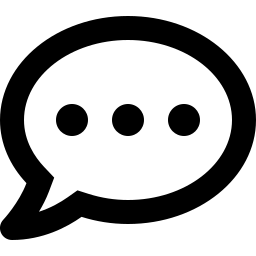أقارب أم عقارب؟.. عادات خارقة على مجتمعنا
بداية أعتذر من القارئ الكريم لهذا العنوان الذي قد يحمل في طياته عنفًا لفظيًّا في الكتابة والقراءة والسمع، كما يؤسفني أن أكتب في هذه الزاوية الاجتماعية الحساسة جدًّا، الذي قادتنا لغير رغبة، ورمت بقلمنا وبصرنا وسمعنا إلى ما كنا لا نتوقعه أو نصدقه، ولكنها مشيئة الله الذي قادتنا إلى ذلك، لعله فيه استنارة وهداية لنا إلى الطريق المستنير وصراطه المستقيم.
مفردتا ”أقارب/ عقارب“ بينهما جناس ناقص، تشابه في الحروف إلا في حرف واحد «أ/ق»، وهذا الحرف أعطى سياقًا ومفهومًا آخر لكل من الكلمتين، وجعل لكل واحدة منهما مفهومًا يبعد عن الثاني بعد المشرقين، بالرغم من أنهما على نفس الوزن ”أَفَاعِل“ وبهذا أعطى نفس الإيقاع بينهما.
”الأقارب“ هم الأرحام، أي السلالة الجينية البشرية، الذي تكونت من آباء وأمهات وتسلسل منها ذرية متفرعة من الذكور والإناث، حتى أصبحت شجرة عائلية لها جذور وأصول وفروع، وقد أولى الإسلام مسألة الأرحام عناية خاصة، إذ وضع مكانة الأرحام في قمة الهرم الاجتماعي وفوق كل طرف آخر من السلالات البشرية الأخرى.
ومن كرم الله سبحانه حين وصف المؤمنين في كتابه الحكيم بأنهم إخوة حيث قال جل شأنه: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» ﴿الحجرات: 10﴾، وكما قال الإمام علي  لمالك الأشتر عند توليه على مصر: ”الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق“، إلا أن هذه المكرمة الإلهية والمنزلة الاجتماعية الرفيعة لا تصل ولا بمقدار رأس إبرة من صفة الإخوة البيولوجية المباشرة، أو أي علاقة رحمية تولدت من هذه السلالة البشرية، بل إن الأرحام ثاني من يسأل عنهم الله بعد الصلاة حين الرحيل إليه.
لمالك الأشتر عند توليه على مصر: ”الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق“، إلا أن هذه المكرمة الإلهية والمنزلة الاجتماعية الرفيعة لا تصل ولا بمقدار رأس إبرة من صفة الإخوة البيولوجية المباشرة، أو أي علاقة رحمية تولدت من هذه السلالة البشرية، بل إن الأرحام ثاني من يسأل عنهم الله بعد الصلاة حين الرحيل إليه.
”العقرب“ هو ذاك الحيوان الصغير الحجم ذو الخطورة العالية، وصاحب المكر والخديعة، والذي يحذر منه خبراء البيئة، ووجوب أخذ الحيطة والحذر من الاقتراب منه أو من احتمالية وجوده في مكان ما، ومن بيئته التي يعيش فيها، ذلك أنه يمتلك سمًّا خطيرًا وقاتلًا، وقد يلدغ في وقت قصير بسبب شدة ما يمتلكه من سم حين لدغته.
يذكر لنا التاريخ مقولة مشهورة عند العرب تقول: ”الأقارب عقارب“، وأنا شخصيًّا لا أعتقد بهذا المثل، لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الفكرية، علما أنه ليس بين يدي بحث يؤكد صحتها أو ينفي مدلولها، الا أن المنظومة الدينية تقول غير هذا، بل تدعو إلى عكس هذا المفهوم تمامًا، بل إن الدين الاسلامي أوصى بالأرحام حتى لو بلغ منهم ما بلغ من الأداء والظلم وما شابه ذلك، فقد أكدت الأحاديث الشريفة على مضمون مؤداه وجوب الصلة والتواصل في كل الحالات والظروف: ”صِل مَن قطعك“، وهذه دلالة واضحة وقاطعة تؤكد خلاف المقولة الواردة على لسان العرب، وهناك كثير من الأدبيات الإسلامية وردت في القرآن الكريم والسنة الطاهرة، تدعو إلى الحفاظ على القيمة الرحمية بين الأقارب وجعل هذه العلاقة الإنسانية الخاصة دائمًا في ود ومحبة وتسامح وتعايش، بل الحث على سرعة الإصلاح ومعالجة أي شرخ قد يقع أو يحدث لهذه العلاقة المقدسة، ومن دون أي تأخير أو تمطيط أو مماطلة مهما كان حجم ونوعية ذلك الجرم الذي حدث فيها.
إذًا أصبحت المفارقة واضحة بين مفهوم الأقارب عند العرب، وبين مفهوم الأقارب أو الأرحام في الإسلام أو في الثقافة الإسلامية.
ولعل سائلًا يسأل: إذا كانت هذه هي أدبيات الدين الإسلامي الحنيف، الذي بشر به سيد الكوني سيدنا ونبينا محمد ﷺ فلماذا نجد في بعض المجتمعات الإسلامية من يجدد جريمة قابيل «القتل ظلمًا وعدوانًا» ويفجعنا بمثلها في الأرحام أو في غير الأرحام من أبناء المجتمع الواحد بين الحين والآخر، ولأجل أسباب تافهة؟
والجواب «باختصار»، بأن الشيطان الرجيم لم يمت فهو موجود وملازم مع ابن آدم بل وحتى مع الأنبياء  إلى آخر لحظة يقبر فيها الإنسان، والرادع الحقيقي لهذا الشيطان الرجيم هما أمران هامان: الوازع الديني والسلوك الأخلاقي النابع من الدين الإسلامي، الذي ينبغي أن يتسلح بهما الإنسان، ذلك أن الوازع الديني هو الأرضية المحصنة للإنسان، والثقافة الأخلاقية الإسلامية هي المنير والموجه لسلوك الإنسان إلى الصواب والطريق المستقيم.
إلى آخر لحظة يقبر فيها الإنسان، والرادع الحقيقي لهذا الشيطان الرجيم هما أمران هامان: الوازع الديني والسلوك الأخلاقي النابع من الدين الإسلامي، الذي ينبغي أن يتسلح بهما الإنسان، ذلك أن الوازع الديني هو الأرضية المحصنة للإنسان، والثقافة الأخلاقية الإسلامية هي المنير والموجه لسلوك الإنسان إلى الصواب والطريق المستقيم.
وهذا بطبيعة الحال يكون ناتجًا عن تربية صالحة تربى عليها هذا الإنسان في أحضان أبوين صالحين، وبيئة يملها روح الإيمان والتقوى، إذ تمثل هذه التربية الصالحة خط الدفاع الأول من الوقوع في الجريمة، وتمثل الحاجز المانع للإنسان من الوقوع في منزلقات الشيطان، لأنه «الشيطان» ليس له قدرة أو سلطان على إغواء الصالحين والمتقين، حيث أكد هذا المعنى ربنا حين قال جل شأنه الكريم: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ». ﴿الحجر: 42﴾.
ومبررات الجريمة اليي يصنعها الشيطان إلى الإنسان لا تعد ولا تحصى، من أجل أن يتمكن منه ويتملك تفكيره لتسهيل عليه الوقوع في أحضان الجريمة والخطيئة، ويؤكد الاختصاصيون في علم الجريمة، أن كل فعل يحمل عنوان ”جريمة/ خطيئة“ فإن فاعلها قد أعدَّ له الشيطان ألف مبرر قد أحاط به عقله وكبَّل به نفسه الإمارة بالسوء.
الحياة عُرفت بصعوبتها وآلامها وضغوطاتها النفسية وتعبها الجسدي، وهذه الإرهاصات الحياتية هي من تصنع الإنسان وتقوِّيه وتصلب إرادته وعزيمته وتشكِّل شخصيته الانسانية والقيادية والفكرية والدينية والثقافية، لكي يكون بعدها قادرًا على خوض التحديات الحياتية الصعبة والمختلفة الذي سوف تواجهه.
وهنا أؤكد على أمر، وهو بأننا لا ندعي أن الأقارب منزهون عن الخطيئة بين بعضهم بعضًا، أو أنه لا يوجد فيهم تفاوت في الأخلاق والتدين والوفاء والمودة والمحبة، بل في الأرحام من يحمل صفات سيئة، كصفات من هم ليسوا بأرحام، ففيهم الصالح كما فيهم الطالح، فيهم من هو في درجة الملاك، وفيهم من هو أدنى من ذلك، وإن كان الصنف الثاني هو القليل.
ومن سمات هذا الصنف «الثاني» أنه كثير الغموض، وأنه يخفي ويضمر ما في قلبه تجاه بعض أرحامه، لأنه يتملكه شيءٌ من الحماقة والحسد والعداوة والبغضاء، بسبب سوء فهم قد حصل من قول أو فعل، أو بسبب حدث ما، وعلى ضوء سوء ذلك الفهم المتسارع قد يتخذ قرارات خاطئة ضده.
وهنا ينبغي علينا أن نفرق في طريقة التعامل ومعالجة هذا المرض الأخلاقي إذا ابتلى به أحد من أفراد الأسرة «لا سمح الله»، مقارنة مع شخص آخر من هو خارج إطار العائلة، وينبغي عدم المساواة بين الحالتين في اتخاذ الموقف وإن تشابه الفعل، وقد يعظم قبح عمل صاحب الرحم. ويجب أن تكون المعالجة مع صاحب الرحم ألطف وأفضل وأرحم، وهنا إشارة إنسانية عامة: كلما كانت الخصومات شريفة كانت قلوبهم أقرب إلى الطهر والنقاء والصلح والهداية، وفي الأرحام ينبغي أن تكون أضعاف ذلك.
وأخيرًا، نسأل الله «تعالى» أن يحمي ويحفظ أرحامنا ومجتمعنا وبلادنا من مثل هذه الجرائم البشعة وغيرها، وأن يبعد عنا هذه الآفات الشيطانية، إنه سميع مجيب.