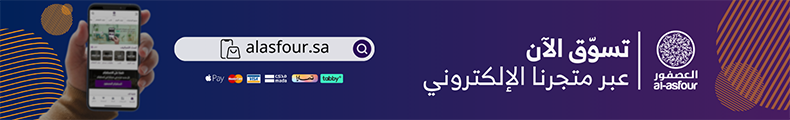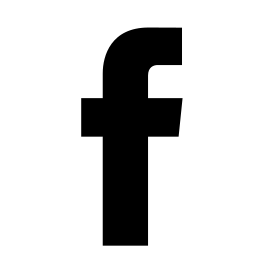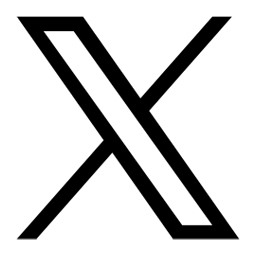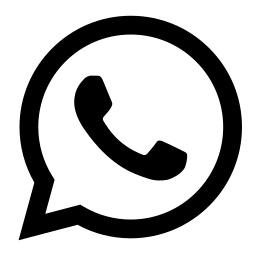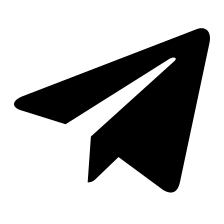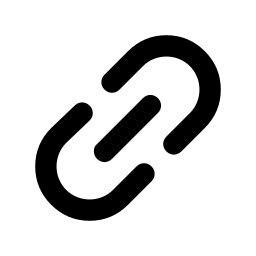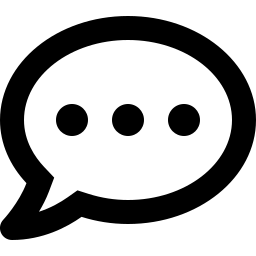في رحاب أدعية الزهراء (ع)
ورد في دعاء مولاتنا الزهراء  : اغفر لي وارحمني إذا توفيتني، اللهم لاتعيني في طلب مالم تقدر لي، وما قدرته فاجعله ميسراً سهلا» «بحار الأنوار ج 92 ص 406».
: اغفر لي وارحمني إذا توفيتني، اللهم لاتعيني في طلب مالم تقدر لي، وما قدرته فاجعله ميسراً سهلا» «بحار الأنوار ج 92 ص 406».
نحيا معالم العلاقة بالله تعالى في موارد الحاجات الحقيقية من خلال هذا المقطع الوارد في دعاء الزهراء  ، ونستكشف من خلال هذه اليقظة الروحية معنى الدعاء الحقيقي وأنه ليس مجرد تحريك اللسان دون عمل وهمة في تغيير الواقع، وإنما هو ومضة فكرية يتآزر معها الوجدان ويتفاعل معها في ساحة العلاقة بالله تعالى، والتماس تغيير سوء الحال من المولى الجليل ليس بجمود على المفردات، بل الدعاء رسم خريطة العمل على أرض الواقع مدفوعا بالأمل بمدبر الأمور.
، ونستكشف من خلال هذه اليقظة الروحية معنى الدعاء الحقيقي وأنه ليس مجرد تحريك اللسان دون عمل وهمة في تغيير الواقع، وإنما هو ومضة فكرية يتآزر معها الوجدان ويتفاعل معها في ساحة العلاقة بالله تعالى، والتماس تغيير سوء الحال من المولى الجليل ليس بجمود على المفردات، بل الدعاء رسم خريطة العمل على أرض الواقع مدفوعا بالأمل بمدبر الأمور.
الأمر الأول الذي يتم الإشارة إليه في هذه التحفة الفاطمية هي مسألة التعلق بالمغفرة والرحمة الإلهية في أصعب المواقف التي يمر بها الإنسان وهو مشهدية الرحيل وحلول المنية، وذلك أنه في تلك اللحظة تغلق صفحات كتاب أعماله فما أغفل عن عمله من الصالحات وصنع المعروف لا يمكن تعويضه حينئذ، كما أن باب التوبة النصوح مفتوح بوجه العبد ليتخلص من تبعات ما اقترفه من السيئات، أما وقد حلت لحظة الفراق فها هو هذا الباب الواسع يغلق أيضا، كما أن مولاتنا الزهراء  توجهنا إلى أدب الخطاب مع الباري سبحانه وتعالى، بما يحمل معاني الافتقار إلى المولى والإقرار بحالة ضعفنا المحيط بنا في الاتجاه المادي والمعنوي، ومنها حالات ارتكاب الذنوب فإنها لم تنشأ من مناوأة أو جحود بالنعم الإلهية، ولكنها كانت لحظات السقوط في براثن الشهوات والأهواء نتيجة الغفلة عن تربية النفس وتنزيهها، وفي تلك الساعة لا ينفع إلا التعلق بالعفو الإلهي بالتجاوز والصفح عما فعلناه، وإلا فإن مقتضى استحقاق العدل الإلهي أن ينال العاصي عقوبة ما اقترف من آثام.
توجهنا إلى أدب الخطاب مع الباري سبحانه وتعالى، بما يحمل معاني الافتقار إلى المولى والإقرار بحالة ضعفنا المحيط بنا في الاتجاه المادي والمعنوي، ومنها حالات ارتكاب الذنوب فإنها لم تنشأ من مناوأة أو جحود بالنعم الإلهية، ولكنها كانت لحظات السقوط في براثن الشهوات والأهواء نتيجة الغفلة عن تربية النفس وتنزيهها، وفي تلك الساعة لا ينفع إلا التعلق بالعفو الإلهي بالتجاوز والصفح عما فعلناه، وإلا فإن مقتضى استحقاق العدل الإلهي أن ينال العاصي عقوبة ما اقترف من آثام.
مولاتنا الزهراء  تأخذ بأيدينا إلى جانب الرحمة الإلهية بكافة مستوياتها، فالعبد يطمع - طمعا ممدوحا - بأن يشمله ذلك العطف والكرم ابتداء من المغفرة، والتي تعني الستر على عورة المرء المعنوية فلا يفتضح بما ارتكبه من سيئات على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة، وأما الرحمة المقترنة بالمغفرة فهي إشارة لما بعد الستر الإلهي وهو الصفح عما بدر من العبد وعدم ترتيب الأثر عليه وهو العقوبة الأليمة، كما أن الرحمة الإلهية تتجاوز محو السيئات إلى مقام تبديلها إلى حسنات، فالتعلق بالرحمة الإلهية انفتاح على ذلك العطاء والكرم الذي لا يحده حد، ورجاء العبد في سعة أمله تعظيم للخالق ومعرفة بصفاته فيرجو منه نيل إشعاع عطاء رحماني.
تأخذ بأيدينا إلى جانب الرحمة الإلهية بكافة مستوياتها، فالعبد يطمع - طمعا ممدوحا - بأن يشمله ذلك العطف والكرم ابتداء من المغفرة، والتي تعني الستر على عورة المرء المعنوية فلا يفتضح بما ارتكبه من سيئات على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة، وأما الرحمة المقترنة بالمغفرة فهي إشارة لما بعد الستر الإلهي وهو الصفح عما بدر من العبد وعدم ترتيب الأثر عليه وهو العقوبة الأليمة، كما أن الرحمة الإلهية تتجاوز محو السيئات إلى مقام تبديلها إلى حسنات، فالتعلق بالرحمة الإلهية انفتاح على ذلك العطاء والكرم الذي لا يحده حد، ورجاء العبد في سعة أمله تعظيم للخالق ومعرفة بصفاته فيرجو منه نيل إشعاع عطاء رحماني.
والرجاء الثاني هو طلب التكوين النفسي المتعلق بالرزق بما يلائم التدبير الإلهي وهو القناعة، فالرزق لا نعرف ما فيه من مصلحة ومنفعة تعود علينا في سعته أو تضييقه، ووظيفتنا الشرعية هي السعي الحثيث لطلب لقمة العيش الحلال وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، وما يطلبه العبد هو أن يهيء له مولاه أسباب الرزق وتسهيل طريقه في البحث عنها ودفع العراقيل والعثرات عن وجهه، فالسعي في طلب الرزق يدخل في إطار حركة الإنسان في شتى مجالات الحياة والتي لا تتأكد نتيجتها بالظفر بها بنحو مستمر، فقد تتخلف النتيجة وتأتي الأمور باتجاه معاكس وهو نوع من الابتلاء والاختبار للإنسان، فهو درس له في علاقته بالسنن الإلهية وتدبيره سبحانه للأمور والتي لا نعرف أين تتجه بأي سعي منا، كما أن وضعنا وحالنا ما بعد الوقوع إما أن يتجه نحو اليأس أو النهوض مجددا متسلحين بمعرفة أخطاء الماضي وأوجه التقصير لتصحيح خطانا، فالمؤمن صاحب صبر ونفس طويل في تحصيل رزقه ولا يعدم الوسيلة، ولكنه يعلم يقينا بأن ما ظفر بهو نصيبه المقدر له، ولا تتنافى القناعة مع الطموح لنحو أفضل وذلك أنه لا تلحقه الحسرة والقنوط مع فوات بعض الحظوظ ولكنه يبذل جهوده لقنص فرص مستقبلية أخرى.
والرجاء الأخير في هذه التحفة هو تيسير الأمور ودفع الصعوبات التي تصادفه وتمنعه لنحو مؤقت من بلوغ مناه، فالعبد يتعلق بالقدرة الإلهية لمساعدة ضعفه وإعانته على تجاوز وتذليل العقبات، وهذا الطلب يأتي - بالطبع - بعد بذل الجهود ولكنه لا يعتقد أنها العامل الوحيد في تحقق المراد، بل هناك توفيق وتسديد إلهي يآزر جهوده لا غنى له عنه في كل أحواله، وأما التسهيل فهو مرتبة تأتي بعد التيسير والمقصود منه دفع العقبات المستقبلية بأن لا تتجدد مرة أخرى.