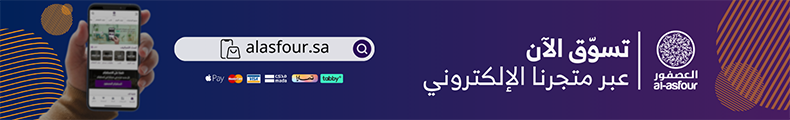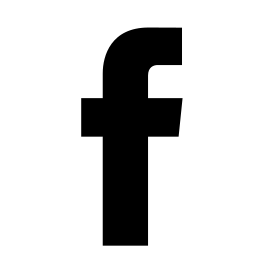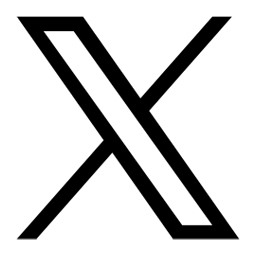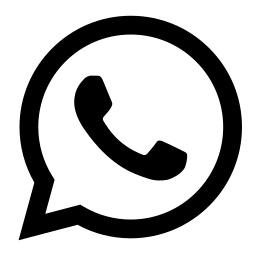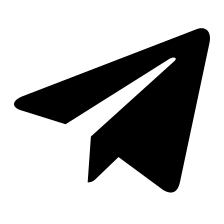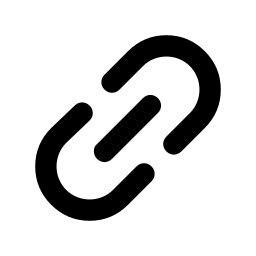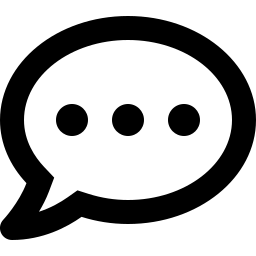التناقض في القرآن الكريم
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
أرسل إليّ أحد الدكاترة من الإخوة الأعزاء سؤالا عن الاختلاف بين القرآن والعلم الحديث، والتناقض بين الآيات القرآنية الشريفة ذاتها، قال فيه نصا: «بخصوص عدم وجود الاختلاف في القرآن الكريم من الملاحظ أنه توجد بعض التناقضات الظاهرة في القرآن، أو مخالفتها للعلم، إلا أنه يتم تأويل ظاهر الآيات لفك التناقض أو الإشكال»
واستشهد على وجود ذلك التناقض بين الآيات القرآنية بقوله تعالى في الآية «162» من سورة الأنعام: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾، إذ كيف يكون النبي أوّل المسلمين في حين أن القرآن يؤكد سبق غيره ﷺ إلى الإسلام، كنبي الله إبراهيم وسائر من سبقه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟!
ولأنه كان يريد جوابا فيه شيء من التفصيل، فقد كتبت هذا الجواب، الذي آمل أن أكون قد وفقت فيه ولو بعض التوفيق، وأن يكون جامعا بين المتعة والفائدة.
سؤالك يتضمن إشكالين:
الأول: وجود الاختلاف بين القرآن والعلم الحديث.
الثاني: وجود التناقض بين آيات القرآن الكريم.
ولو بدأنا بالجواب عن ادعاء وجود الاختلاف بين القرآن والعلم، فيمكننا أن نقول:
الحقيقة أنه لا يوجد تناقض من هذا النوع أبدا وعلى الاطلاق، وفي حدود اطلاعي لم أر من ادعى وجود هذا الاختلاف وتمكن من إثباته بدليل صحيح، بل العكس هو الصحيح، فإن كبار العلماء والمفكرين في مختلف التخصصات يؤكدون التوافق بين العلم والقرآن، ويؤكدون سبق القرآن للعلم الحديث فيما أشار إليه من قضايا علمية، ولدي موضوع طويل يتعلق بهذا السبق ضمّنته بعض اعترافات وتصريحات العلماء بمختلف تخصصاتهم بوجود هذا التوافق بين العلم والقرآن، وشهاداتهم بالسبق القرآني للعلم فيما أشار إليه من قضايا علمية.
وأما عن دعوى وجود التناقض بين آيات القرآن نفسها، فهي لا تختلف عن سابقتها في عدم الصحة، وعدم تمكن من يدعيها إثباتها بدليل صحيح، بل الصحيح هو عدم وجود التناقض أو الاختلاف في القرآن العزيز، لأنه من عند الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، كما يقول سبحانه في الآية «82» من سورة النساء.
وهو نفي لكل أنواع الاختلاف في القرآن، فلا اختلاف تناقض، ولا اختلاف تفاوت، ولا اختلاف تشابه، ولا اختلاف معاني... بل هو ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِير﴾ كما يقول عز وجل في الآية «1» من سورة هود.
ولأنه من عند الله، فهو كتاب يخلو من كل اختلاف، ولو كان من عند غيره تعالى لما وجدنا فيه هذا الإحكام، ولما ارتفع عنه كل اختلاف، بل لكان مملوءً بالاختلافات الكثيرة التي قد تصل إلى حدّ أن يناقض بعضها بعضا.
ولكي نتأكد من وجود ذلك التناقض من عدمه، لابد لنا أن نعرف معنى التناقض أولا، وفي حال عدنا إلى علماء المنطق لرأينا أنهم يعرفون التناقض - كما في ص155 من كتاب «المنطق» للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر - بأنه «اختلاف في القضيتين، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة».
وبعيدا عن الشرح والتفصيل، فلو أخذنا مثالا على ذلك «وجود الروح من عدم وجودها» فإن إثبات وجودها يقتضي لذاته نفي القول بعدم الوجود، وهكذا الحال في كل قضية أخرى ذات طرفين متناقضين، فإننا متى أثبتنا طرفا منهما انتفى الطرف الآخر، ولذلك قيل: «النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فلا يمكن أن يكون هذا الكون موجودا وغير موجود في وقت واحد، ولا يمكن أن يرتفع وجوده وعدم وجوده في وقت واحد، بل لابد أن يتصف بواحدة من الصفتين «الوجود أو العدم» ومتى اتصف بصفة انتقضت الصفة الأخرى، وبما أن الكون موجود، ينتقض القول بعدم وجوده.
ولو عدنا إلى آيات القرآن الكريم لما وجدنا بينها ما ينطبق عليه هذا الوصف، بمعنى أنه لا توجد فيه آية تثبت شيئا وتنفيه في وقت واحد، بل ولا توجد آيات تثبت قضية، وآيات أخرى تنفي ذلك الإثبات، لنقول بوجود التناقض بين آياته.
ولو وجد هذا النوع من الآيات لما أمكن رفع ذلك التناقض الموجود بينها لا بالتأويل ولا غيره، لأن التناقض لا يمكن رفعه من الأصل لا في آيات القرآن الكريم ولا في غيرها، فكما أننا لا يمكن أن نرفع التناقض بين القول بوجود الروح وعدم وجودها، لأنه متى قلنا بالوجود انتقض القول بعدم الوجود، ومتى قلنا بعدم الوجود انتقض القول بالوجود، وليس لدينا أي حل في رفع هذا التناقض أبدا وعلى الإطلاق، فكذلك الحال في آيات القرآن الكريم، فلو كان يوجد بينها تناقض لما أمكننا رفعه بأي حال من الأحوال.
أعتقد أنه بما قدمناه يتضح لنا عدم صحة القول بوجود التناقض «بمعناه الحقيقي» في القرآن، ومتى انتفى وجود هذا التناقض انتفى هذا الإشكال من أساسه، لكننا زيادة في التوضيح، واستطرادا في الموضوع نقول:
إن من خصائص القرآن أن فيه محكما ومتشابها، كما يقول تعالى في الآية «7» من سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.
ومن القواعد القرآنية جعل الآيات المحكمات حاكمة على الآيات المتشابهات، وذلك لأن الآيات المحكمات ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ وأصله، فيجب إرجاع المتشابهات إليها، وعرضها عليها، بمعنى أنه إذا كانت الآية متشابهة، وتحتمل أكثر من معنى، أو كان ظاهرها يدل على معنى لا ينسجم مع المفاهيم الدينية الصحيحة، فيجب أن نعيدها إلى الآية المحكمة لنفهم معناها الصحيح، والمنسجم مع الدين، وذلك لأن من خصائص الآيات المحكمات الوضوح في المعنى والدلالة، عكس الآيات المتشابهة اللاتي ليس فيها ما في الآيات المحكمات من وضوح المعنى ودلالته، ولذا يجب أن نستعين على فهم الآية المتشابهة بالآية المحكمة.
فمثلا من الآيات المحكمة قوله تعالى في الآية «11» من سورة الشورى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، فهي آية محكمة وواضحة في معناها ودلالتها، لذلك يجب أن تكون هي الحاكمة على جميع الآيات المتشابهات المتعلقة بالذات الإلهية المقدسة، كما هو الحال في الآيات التي بظاهرها تنسب التجسيم إلى الله عز وجل، وذلك لأنه متى فسرنا تلك الآيات بحسب ذلك الظاهر، ونسبنا التجسيم إلى الله تبارك وتعالى، نكون جعلنا له مثيلا، أو شبهناه بسائر الأشياء، وهو يعارض أو يخالف تلك الآية المحكمة، ونفيها أن يكون له مثيل أو شبيه سبحانه وتعالى.
لذلك تجد الذين نسبوا الأعضاء كاليد أو غيرها إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا: إن ذلك كله بما يليق بجلاله.
وما قالوا ما قالوا إلا فرارا من الوقوع في ذلك التناقض، وهو فرار لا ينجينا من المشكلة، ولا يخلصنا منها على كل حال، لأنه متى نسبنا الأعضاء قلنا بالتجسيم، ومتى قلنا بالتجسيم نشأت لدينا الكثير من المحذورات التي من بينها التناقض بين التنزيه والتجسيم.
ولذا أصبح من المهم جدا أن نلتزم بتلك القاعدة القرآنية الأصيلة، المتمثلة في وجوب رد المتشابه إلى المحكم، سواء في الآيات المتعلقة بالذات الإلهية المقدسة، أو في غيرها من الآيات.
ومع وجوب إرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمات، كذلك يجب مراعاة المعاني اللغوية في التفسير والشرح والبيان، بمعنى أننا حين نرجع الآية المتشابهة إلى المحكمة، فلا يصح حينها أن نفسرها كيفما اتفق، فقط لكي نتخلص من التناقض أو غيره من الإشكالات، بل يجب أن نقوم بتأويلها تأويلا صحيحا ينسجم مع الآية المحكمة من جهة، ويتوافق مع المعاني اللغوية للكلمات من جهة أخرى، وذلك لأن التأويل ليس معناه وجود تناقض في الآيات القرآنية ونحن نلجأ إليه لنرفع ذلك التناقض كما جاء في إشكالك أو سؤالك، بل التأويل «عند قدما المفسرين» هو التفسير، وبيان المعنى المراد من اللفظ.
ووفق هذا الرأي يكون التأويل هو نفسه التفسير والبيان.
وعند المتأخرين منهم، التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ.
ولكن ليس معنى هذا أن التأويل يعني حمل النص «سواء كان قرآنا أو غيره» على خلاف ظاهره كيفما اتفق، وإنما معناه أن ظاهر النص «سواء كان قرآنا أو غيره» قد يدل على معنى غير صحيح وإن توهمناه صحيحا، في حين أننا لو أولناه إلى معناه الصحيح، أي «أرجعناه إلى معناه الصحيح» لاتضح لنا خطأ تلك الدلالة الظاهرية، أو دعنا نقول: لاتضح لنا أن معناه الحقيقي يختلف عما فهمناه من ظاهره.
ولاحظ أنني قلت: أرجعناه إلى معناه الصحيح، لأن التأويل - في اللغة العربية - كما يأتي بمعنى التفسير والبيان، يأتي بمعنى الرجوع، كما لو قلنا: أوّل الأمر إلى أهله، أي أرجعه إليهم.
كما قد يطلق التأويل ويراد منه العاقبة، وما يؤول الأمر إليه، كما جاء ذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة، كقوله تعالى في الآية «6» من سورة يوسف: ﴿وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، أي يعلمك ما يعود إليه معنى الأحاديث، وقوله سبحانه في الآية «26» من السورة نفسها: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، أي نبئنا بحقيقة هذه الرؤيا وما يؤول إليه أمرها.
حين نريد القيام بتأويل هذا النص أو ذاك، فلابد أن نلتزم بقواعد التأويل وضوابطه، والتي منها تأويلنا للنص موافقا للغة العربية، فحين نأتي مثلا إلى قوله تعالى في الآية «47» من سورة الذاريات: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾، فلو أخذنا بظاهرها فقط، فقد يتبادر إلى ذهننا أن لله تعالى أيد بها بنى السماء، وهذا مخالف لتلك الآية المحكمة التي يقول فيها الحق سبحانه في الآية «11» من سورة الشورى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.
وبهذا نكون قد وقعنا في التناقض الذي لا يمكن رفعه، لأننا نزهنا الله من جهة، ونسبنا له الأعضاء والتجسيم المخالف للتنزيه من جهة أخرى.
والسبب في بروز هذا التناقض ليس وجوده حقيقة، وإنما ما وقعنا فيه نحن من خطأ في المنهج حين تفسيرنا لهذه الآية، إذ أننا خالفنا القاعدة القرآنية التي تجعل الآيات المحكمة حاكمة على الآيات المتشابهة، وهذه المخالفة هي التي أوقعتنا في ذلك الاشتباه، المؤدي إلى الوهم بوجود التناقض بين التنزيه وعدمه في القرآن الكريم.
ولو أننا جعلنا الآية المحكمة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ حاكمة على هذه الآية المتشابهة: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ لما فسرناها بذلك التفسير، الذي أوهمنا بوجود ذلك التناقض، ولفهمنا أنه ليس المراد بالأيدي في الآية هو ذلك العضو الذي يلزم منه التجسيم، بل المراد شيء آخر لا يلزم منه لا التجسيم ولا غيره من المحذورات.
ومتى خرجنا بنتيجة أنه ليس المراد من الأيدي ذلك العضو من الجسم، وعلمنا أن هذا تفسير خاطئ وتلزم منه محذورات منطقية وعقائدية كثيرة، قادنا ذلك إلى القيام بتأويل الآية بما يوافق المعنى الحقيقي، وهو ما لا يمكن أن يتمّ إلا بأن يكون ذلك المعنى صحيحا في اللغة العربية من جهة، ومتوافقا مع معنى الآية الكريمة من جهة أخرى، مما يعني أننا حين قلنا بأنه ليس المراد بالأيدي في الآية هو العضو نفسه، فإننا بذلك لم نحمل الآية على خلاف ظاهرها واقعا، بل ذكرنا ما يناسبها من معنى في اللغة، وذلك لأننا في حال عدنا إلى اللغة العربية سنرى أن من بين معاني كلمة اليد:
العضو من الجسد.
واليد: مقبض الشيء، فيد السيف مقبضه، وهكذا في سائر الأشياء.
واليد: الأنصار، فهم يد واحدة على غيرهم، بمعنى أنهم مجتمعون لنصرة بعضهم.
واليد: الذلة، كما في قوله تعالى: واليد النعمة والإحسان، نقول: لزيد يد على عمر، أي له إحسان ونعمة عليه.
واليد: القوة والقدرة والسلطان، كما لو قلنا: بسط يده على المدينة، أي بسط قدرته وقوته وسلطانه على المدينة.
ومنه قوله تعالى في الآية «29» من سورة التوبة: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، والمعنى في قوله: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ﴾ أي حتى يدفعوا الجزية إليكم عن قدرة لكم عليهم، فتكون اليد - هنا - بمعنى القدرة.
إلى غير ذلك من المعاني لليد في اللغة العربية، وبما أننا حين أرجعنا الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة، اتضح لنا أنه يستحيل أن يكون المراد من الأيدي في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ ذلك العضو من الجسم لمخالفته لمحكم القرآن، الذي هو الحاكم على المتشابه، ولما يلزم من ذلك من الوقوع في التناقض من التجسيم وعدمه، فلابد وأن نؤول الآية إلى معناها الصحيح، أي نرجعها «لأن التأويل هو الرجوع كما بيناه»
ولكي نرجعها إلى معناها الصحيح، فلابد أن ننظر في تلك المعاني اللغوية لليد، لنرى منها ما يتوافق مع معنى الآية الكريمة بحسب ظاهرها، ثم نفسرها به.
وفي حال رجعنا إلى تلك المعاني، سنرى أن مما يتوافق مع الآية هو «النعمة والإحسان» وحينها سيكون المعنى كما يقول السيد الطباطبائي في ج18ص381 من الميزان: «والسماء بنيناها، مقارنا بناؤها لنعمة لا تقدر بقدر، وإنا لذووا سعة وغنى، لا تنفد خزائننا بالإعطاء والرزق، نرزق من السماء من نشاء، فنوسع الرزق كيف نشاء».
أو نفسرها بالقوة والقدرة والسلطان، فيكون المعنى: والسماء بنيناها بقوتنا التي لا تحد، وقدرتنا المستطيلة على كل شيء، وسلطاننا المبسوط على جميع الأشياء، تماما كما لو قلنا: بسط يده على المدينة، أي بسط قوته وقدرته وسلطانه، وليس ذلك العضو من بدنه.
وتفسير اليد في هذه الآية بالقوة والقدرة والسلطان، ربما هو أوفق من تفسيرها بالنعمة والإحسان، وربما هو الذي يذهب إليه الأكثر، وقد ذكره السيد الطباطبائي في الميزان كما ذكر التفسير بالنعمة والإحسان.
وسواء أولناها وفسرناها بالنعمة والإحسان، أو بالقوة والقدرة والسلطان، فعلى كلا التأويلين والتفسيرين نحن لم نخالف اللغة العربية من جهة، كما أننا ذكرنا الأليق بالآية من جهة أخرى، مما يعني أننا لم نلجأ إلى التأويل بقصد أن نرفع التناقض الذي هو غير موجود من الأصل، بل نحن بهذا التأويل نكون وافقنا ظاهر الآية ولم نخالفه، كما أن تفسيرنا لليد بالقوة والقدرة والسلطان هو تفسير حقيقي، لم نلجأ فيه إلى المجاز كما قد يتصور البعض.
وكذلك الحال فيما لو عدنا إلى الآية الكريمة التي تفضلت بذكرها كشاهد على وجود التناقض الظاهري في القرآن، والمتمثلة في قوله تعالى في الآية «162» من سورة الأنعام: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾، فإننا حين نؤولها، فليس معنى ذلك أننا نحاول رفع ما في القرآن من تناقض بين هذه الآية وبين ما يثبته القرآن من سبق إسلام الأنبياء السابقين لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما معنى تأويلها هو إرجاعها إلى معناها الصحيح، الموافق لظاهرها وليس المخالف له واقعا، كما لو فسرناها بأنه ﷺ أول المسلمين من قومه وأمته.
فإن هذا التفسير لا يخالف ظاهر الآية أولا، كما أنه لا ينفي سبق الأنبياء السابقين لزمانه للإسلام، تماما كما لو قلت أنت عن نفسك أنك أول الحاصلين على الدكتوراه في بلدك في عصرك.
فقولك هذا لا ينفي أن يكون هناك من سبقك إلى الحصول على تلك الشهادة في البلاد الأخرى، بل ولا لمن حصل عليها في بلادك في العصور السابقة، لأنك تتكلم عن عصرك وليس عما سبقه.
أو نؤولها بأنه ﷺ الأرفع درجة، والأعلى منزلة في إسلامه من كل أحد بمن في ذلك من سبقه زمانا من الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيكون معنى «أول» في الآية هو «الأعلى والأرفع في الدرجة» ليكون هو ﷺ الأول في الدرجة في الإسلام على السابقين واللاحقين على السواء، سواء من الرسل والأنبياء أو غيرهم.
وأيضا لو تلاحظ فإننا بهذين التأويلين والتفسيرين لم نرفع تناقضا، بل أولنا الآية بما يوافق معناها الظاهر منها، بمعنى أننا أرجعناها إلى المعنى الصحيح منها، دون حتى أن نخالف ظاهرها في الدلالة والمعنى.
وكذلك الحال في جميع الآيات القرآنية، لا يوجد بينها أي تناقض ولا اختلاف أبدا وعلى الإطلاق، وهذا من دلائل عظمة القرآن، وأنه فعلا كتاب إلهي صادر من عند الله عز وجل ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ كما يقول سبحانه في الآية «82» من سورة النساء.
ربما هناك بعض الأسباب التي تجعلنا أو تجعل البعض منا يعتقد أو يتوهم وجود التناقض في القرآن الكريم.
ومن بين هذه الأسباب المؤسفة حقا، أن هذا المفسر أو ذاك يحاول إسقاط عقيدته بما فيها من أخطاء على القرآن الكريم، مما يجعله يخضع القرآن لمعتقداته، ويحاول تفسير آياته بما يوافقها، ويتفق معها، ويثبت صحتها، بدل أن يصحح عقيدته وفق ما يدل عليه القرآن حقيقة، فهو ينتصر لعقيدته بالقرآن لا أنه يقوم بتفسيره، وبيان معاني آياته.
ومن مشاكل هذا النوع من التفسير أنه يجعل كل ما في تلك العقيدة من أخطاء يبرز في القرآن الكريم، لتكون كأنها فيه وليس في تلك العقيدة واقعا.
أو قد يبرز لنا هذا التناقض أو غيره من المشاكل نتيجة تطفل من هو ليس بأهل للتفسير، بل وقيام كل من هب ودب بتفسيره فقط استنادا إلى علمه القليل، وثقافته البسيطة، وعقله القاصر، وفكره الناقص، وإدراكه المحدود، ورأيه الخاطئ، تماما كما هو واقع وشائع اليوم لدى الكثير من شبابنا ونخبنا الثقافية، خصوصا حين اقتنعوا ببساطة القرآن، وسهولة فهمه، وإمكان إدراك غاياته ومقاصده لكل أحد، بحجة أن الله عز وجل يسّره للذكر، وجعل فهمه متاحا للجميع، كما يدل عليه - بزعمهم - قوله تعالى في الآية «22» من سورة القمر: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾.
ولهذا نحن الآن نرى العجب العجاب في محاولة هذا أو ذاك إبطال هذه العقيدة أو تلك القضية العقائدية بهذه الآية أو تلك، ومحاولة ذاك إثبات خطأ هذا الرأي الفقهي، أو تلك المسألة التشريعية بهذه الآية أو تلك، حتى أصبح الكل منظرا للدين، ومصححا للفكر الديني على مستوى العقيدة والتشريع معا، مستدلا على صحة فعله هذا بتمكنه من فهم القرآن، وقدرته على تصحيح الفكر الديني في عقائده وشرائعه بالقرآن نفسه، الذي يسّر الله فهمه وإدراك معارفه لكل أحد، حتى دون دراسة أي علم!!
وإذا كان هذا ينطلق في فهم القرآن أو تفسيره من عقيدته، وذاك من رأيه، والآخر بحسب فهمه وذوقه... فمن الطبيعي جدا أن يبرز لنا الخطأ والتناقض والاختلاف في القرآن.
ولكن بغض النظر عن تطفل كل أحد على القرآن وتفسيره، بل حتى لو فرضنا أنه لم يقم بتفسيره إلا الذين هم مؤهلون لذلك، فحتى هؤلاء من الممكن أن يشتبهوا في الفهم، ونحن إنما ندعي عدم وجود التناقض في القرآن ذاته وليس في فهمنا له، وفرق كبير جدا بين الأمرين، إذ من الممكن أن يكون فهمنا هو الخاطئ، لا أن الخطأ موجود فعلا في القرآن الكريم.
ولعل خير مثال يوضح لنا هذه المسألة تلك الحادثة التي تنقل في التاريخ من أن أبا يوسف، يعقوب بن إسحاق الكندي، فيلسوف العراق في عصره، حاول تأليف كتاب يثبت فيه وجود التناقض في القرآن الكريم، واشتغل على ذلك زمانا، إلى أن التقى أحد تلامذته بالإمام أبي محمد الحسن العسكري، فقال له الإمام  : أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
فأجابه تلميذ الكندي: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو غيره؟!
فقال له الإمام: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟
قال: نعم.
فقال الإمام: صر إليه، وتلطّف في مؤانسته، ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة فقل له: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك، فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟
فإنه سيقول لك: إنه من الجائز.
لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك، فقل له: فما يدريك لعله أراد غير هذا الذي ذهبت أنت إليه، فيكون واضعا لغير معانيه.
وحين عاد الرجل إلى الكندي ألقى عليه ما أملاه الإمام العسكري  .
.
فقال له الكندي: أعد عليّ.
فأعاد عليه، فتفكر في نفسه، ورأى ذلك محتملا في اللغة، وسائغا في النظر، فالتفت إلى تلميذه فسأله: أقسمت عليك إلا ما أخبرتني من أين لك هذا!
فأجباه: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك.
فرد الكندي: كلا، ما مثلك من يهتدي إلى هذا، عرّفني من أين لك هذا؟
فقال: أمرني به الإمام أبو محمد.
فقال الكندي: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت.
ثم عمد الكندي إلى كتابه فأحرقه.
ولكي نكون منصفين مع الكندي، فإنه من الصعب جدا القطع بصحة هذه الحادثة، التي نقلها ابن شهراشوب في ج4ص457-458 من كتابه «مناقب آل أبي طالب» عن أبي القاسم الكوفي في كتاب «التبديل»
فهي حادثة مرسلة، فلا يمكن الاعتماد عليها فقط في الإثبات، وبحسب ما يشير إليه السيد محمد الصدر في ص196 من المجلد الأول من «موسوعة الإمام المهدي» المعنون «تاريخ الغيبة الصغرى» فإنه «لم يجدها في المصادر الأخرى لتاريخنا الخاص»، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في تاريخ الكندي ما يدل على أنه مرّ بهذه المرحلة من الشك في القرآن، والقول بوجود التناقض فيه، بل من البعيد جدا أن يقع مثله في مثل هذا الاشتباه.
وسواء صحت هذه الحادثة أو لم تصح، فالشاهد منها هو «الفكرة» المنتزعة مما أدلى به الإمام من أنه ليس بالضرورة أن يكون مراد الله هو ما فهمناه من القرآن، حتى نأخذ من فهمنا دليلا على وجود ذلك التناقض بين آياته البينات.
وعليه فواجبنا «خصوصا نحن كمسلمين، ونعتقد أن القرآن منزل من رب العالمين، على قلب خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» أن نصدق الله فيما أخبرنا به من عدم وجود الاختلاف في كتابه لا بالتناقض ولا غيره، وفي حال تصورنا تعارضا بين القرآن والعلم، أو وجود التناقض بين آياته، فيجب أن نتهم فهمنا للقرآن وليس القرآن ذاته، وذلك للتسالم على أن ما عندنا من علم ومعرفة بالقرآن إنما هو نتاج فهمنا لآياته، والذي ليس بالضرورة أن يكون فهما صحيحا وموافقا لمراد الله سبحانه وتعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين